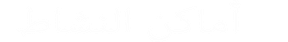الحياة
بيتينا هينن عياش عن نفسها
عن مرحلة الطفولة
قد يطيبُ لأحدهم وصف طفولتي وفترة شبابي في زولينغن بالسعيدة رغم معاناتنا في سنوات ما بعد الحرب مع الجوع والبرد. لا زلتُ أذكرُ جيدًا أننا كنا ننامُ جميعًا في غرفةٍ واحدةٍ ونقتاتُ على اللفت المطبوخ، ولا زالت تراودُني أيضًا اللحظةُ التي حصلنا فيها على الخبز لأول مرة وطلب منا والدي أن نصلي. كان والدي يقضي لياليه في تأليف قصائد ما انفكت أمي تقرأها علينا دائمًا لتترك بكل تأكيد الانطباع الأعمق عن شبابي. وكان معلمي الرسام الفنيّ، إرفين بوفين، يبادلُ الصور مقابل الطعام حتى لا نتضوَّر جوعًا. ورغم هذا الوضع العصيب الذي كنا نمر به في هذه السنوات، إلا أنه ظل يرسم يوميًا. ومن ثم كان منزلنا بمثابة ملتقى يجمعُ المهتمين بالفنون والموسيقى والأدب، وكانت أمي تحسنُ ضيافتهم وتكرمهم. وهكذا أتذكَّر الزيارات المتكررة للفنانين والمثقفين إلى "صالون" والديَّ الأسبوعيّ. ولا يسعني في هذا المقام إلا ذكرُ القليل منهم: السياسي وراعي الفنون الدكتور كروننبيرج، وعازفة البيانو السيدة إيلي ناي، والرسام البروفيسور جورج مايسترمان، والنحَّاتة السيدة ليز كيترر، والكاتب الدكتور هاينز ريسه وغيرهم الكثير. وكنا نقطع أنا وأختي مسافاتٍ طويلة سيرًا على الأقدام حتى نصل إلى حي هوهشايد حتى يتسنى لنا الذهاب إلى مدرسة أوجست ديكه شوله بالترام من هناك. كنا نكره مغادرة المنزل قبل أن ينظرَ أبي من نافذة الممر في الأعلى ويقولَ بصوتٍ عالٍ: "أتمنى لكما نومًا هادئًا". وكثيرًا ما كنا نعودُ أدراجنا وقد لعبت الوساوسُ برؤوسنا، عندما كان ينسى والدي توديعنا بكلماتٍ طيبة.


فترتي الدراسية
لطالما لقي رسمي كلمات الإطراء في المدرسة. وما انفكت معلمة الرسم يوهانا بوسر تثني عليَّ وتدعمني دائمًا. وكان السرور يعلو وجه السيد إرفين بوفين بالتطوُّر الذي أحرزه. كان متيقنًا أنني سأغدو رسامةً عندما رأى الرسومات المُجسَّدة التي رسمتُها لأبناء أختي. غير أني كنتُ أحبُ أيضًا تأليف المسرحيات ومغامرات السفر والقصائد بكل شغفٍ ونهم. كان هوسي كبيرًا جدًا لدرجةٍ كنتُ أكتبُ معها مؤلفاتي بكل نشاطٍ واجتهاد حتى في الترام. وكان عامل شغفي الثالث – يمكنكم الضحك الآن – هو الرقص. وساهمت معلمة اللغة الألمانية السيدة شيلدمان في كتاباتي إسهامًا نشيطًا. كانت تنظر إلى مقالاتي بشكلٍ مختلف جدًا يجعلها تبدو وكأنها غيرُ قابلةٍ للنقد. بدورها اشترت معلمتي، السيدة دوروثيا روش، صوري الأولى في شبابي ولما أبلغُ من العمر 13 عامًا. وعليه لا تزالُ صداقتي مع السيدة روش وتقديري لها قائمين إلى يومنا هذا. وكنتُ أقضي عطلتي الدراسية إما بالسفر مع السيد إرفين بوفين إلى مدينة فايل آم راين حتى نرسم نقطةً حدوديةً ثلاثية أو أتوجَّه معه إلى جزيرة سيلت صوب كلابهولتال، وتحديدًا إلى مخيم لتعليم الكبار كان العديد من المثقفين والفنانين في ذلك الوقت يلقون فيه محاضراتٍ وندوات. وهناك كنتُ أرسم لوحاتٍ مُجسدة بالكامل لشبابٍ صغار بكلٍ شغف وحب.

أول رحلات الرسم إلى السويد والنرويج وتيسينو
لم يكد عمري يبلغ 18 عامًا حتى اطلع السيد كارل شميدت روتلوف على رسوماتي لدى العارضة هانا بيكر فوم راث من فرانكفورت (في معرض فنون فرانكفورت)، وقد لاقت إعجابه واستحسانه بصورة منقطعة النظير. حيث كتب لي ليخبرني بضرورة ارتداء الغمامة وأن أكون مخلصة وصادقة مع نفسي. بالإضافة إلى أننا كنا نسافر كثيرًا إلى السويد والنرويج، لأنني كنتُ مولعةً بالمناظر الطبيعية الخلابة والمواطنين القاطنين هناك. كما أشاد الشاعر النرويجي داجفن زويلجماير برسومات المناظر الطبيعية التي كنت أرسمها لوطنه فاشتراها. كانت السيدة زويلجماير ابنة قائد ناقلة نفط، ولن أنسى قط صورة أسطول ناقلة نفط ضخم راسٍ في ميناء صغير للغاية. عندما أخبرني الناس أن صاحب أسطول الناقلات كان يعيشُ في منزلٍ خشبيّ صغير أحمر أمامنا وبدا صغيرًا أمام السفن الفولاذية الضخمة، كان هذا في الوقت، الذي فكَّرتُ فيه في منازلنا القديمة في زولينغن، التي تحسَّنت صورتُها في مخيلتي على الفور. فإذا ظل مليونيرات الملاحة البحرية قاطنين في منازلهم الخشبية القديمة، يمكن عندئذٍ للفنانين أيضًا العيش في منازلهم القديمة نصف الخشبية. استقبلنا الزوجان أرنا وبيير ميلده، مدير ميناء مدينة ساندنيسيون في ذلك الوقت، في شمال النرويج على جزيرة ألستن عند سفح سلسلة جبال زيبن شفيسترن. وكان سكان الجزيرة يترددون علينا كل ليلة حتى يشاهدوا مدى تقدمنا في رسم صورنا. وهذه - تحديدًا - هي الأجواءُ المناسبة لعمل أي فنان. شكَّلت الرحلاتُ العديدة إلى النرويج سنوات إبداعي المبكرة إلى حدٍ كبير. وكان مُقرَّرًا عرضُ هذه الصور في معرضٍ يُقام في زولينغن، حيثُ تُعرض أعمالي السابقة والمتأخرة التي لم يسبق لها أن رأت النور. وكانت التجربةُ اللونية هي الضوء. وكان لونُ الضوء يتشكَّل في كافة أنحاء أوروبا. كما تعتبر شمس منتصف الليل فريدة في النرويج بألوانها الرائعة. وتمثل تيسينو، ذلك الجزء الإيطاليّ من سويسرا، تجربةً أخرى رائعةً بالنسبة لي، حيث كانت معقلًا للمناظر الطبيعية في الشمال بفضل نباتاتها شبه الاستوائية، ولكنها كانت تشترك في العظمة مع الشمال. وما لم أكن أعرفه في ذلك الوقت هو أن زهور تيسينو الملونة سوف تمثل المعبر الذي سأمر من خلاله إلى أفريقيا.
سنوات الدراسة في كلية الفنون على يد بروفيسور أوتو جيرستر في كولونيا

لكن لا يجوزُ لي الآن أن أنسى سنوات دراستي. ففي عام 1954، وبينما لم أبلغ من العمر إلا 16 عامًا، التحقتُ بمدرسة الفنون، والآن كلية الفنون في كولونيا، وكان يُطلق عليها قديمًا اسم مدارس كولونيا المهنية. ومن جهته كان بوفين يرى أنه من المهم للغاية أن أتعلم رسم العُري والبورترية والتلوين. حيث كان يؤمن بأن تمثيل وتجسيد الإنسان هو أهم شيء في مهنة الرسم. حتى أن الفنان ليوناردو دا فينشي كتب أن الفن هو تمثيل الإنسان بروحه. أردتُ الالتحاق بصف بروفيسور أوتو جيرستر بالضرورة لتعلم فن رسم اللوحات الجدارية الضخمة وأجريتُ امتحان القبول. إلا أن الأعمال التي تقدَّمتُ بها لهذا الامتحان وتلك التي أجريتها فيه سمحت لي بتخطي ثلاث سنوات من التدريب على الرسم، ومن ثم قبلني بروفيسور أوتو جيرستر مباشرةً في صف تعلم اللوحات الجدارية الضخمة. كنتُ الفتاة الوحيدة في الصف بخلاف فتاةٍ ألمانية كوبية على مستو عالٍ من الموهبة ولكنها كانت نادرًا ما تأتي إلى الصف. عندما كان الرسامون يتبادلون النكات الإباحية كانوا يحبسونني في الشرفة حتى يتدخل بروفيسور جيرستر ويضع حدًا لهذه المهزلة ويمنع الطلاب من حبسي في الشرفة. لا زلتُ أتذكَّر جيدًا السيد كونهين من ريمشايد، ذلك الذي أصبح فيما بعد راهبًا بوذيًا في بورما. وبعد مرور فترة من الزمن انضمت سيدتان شابتان إلى صفنا، فكان التلاميذ الذكور يحومون حولهما محاولةً منهم لإثارة إعجابهن وكان هذا يزعجني كثيرًا ويشعرني بالإهانة لأنني كنت صغيرة جدًا في أعينهم حتى يلتفتوا إليّ. كنا نقضي الصباح ونصف وقت الظهيرة فقط في التدرب على رسم العُري. فأشار أوتو جيرستر إلى أهم شيء: الانتباه إلى التفاصيل والوضعية المناسبة التي يقف عليها الشخص المقرر رسمه. فلا يعرف الشخص العادي غالبًا مدى صعوبة رسم شخص بصورة مقنعة وهو واقف. والخطر الأكبر في هذا النوع من الرسم أن يقع الشخص على ورق الرسم أو يفقد توازنه بفعل عوامل محيطة. حتى أن الرومان أبرزوا هذه الركيزة الأساسية في أعمالهم الفنية وتماثيلهم بصورة هائلة. ومن ثم كان يتوجب على الرسام قضاء ساعة في رسم العُري يوميًا. وكنا نقضي فترة ما بعد الظهيرة في رسم اللوحات الجدارية من الكرتون. وفي هذا الوقت لم أكن أجرؤ على رسم عدة أشخاص في آنٍ واحد، ولكنني كنت أصب تركيزي في البداية على شخص واحد فحسب. وبعدما انتهينا من إعداد الرسومات من الكرتون شرعنا في الرسم بألوان الكازين وهي تشبه ألوان الجواش. ودومًا ما كان يزعجني الغلاف الأبيض في ألوان الكازين، الذي كان يُزال عند تجفيف الطلاء الرطب. وهذه التقنية كانت مشابهة جدًا للألوان المائية، لأن الرسم كان يتحسن بصورة طفيفة باستخدامها. كان لدى بروفيسور أوتو جيرستر تصوراتٌ مُعيَّنة عن الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه الرسمة الجيدة، وقدم إرشادات لهذا الأمر، كنت أنظر إليها على أنها حيلة ذكية في أغلب الأوقات. فلا أنسى أبدًا تعبيره: "لا ترغبي في الخضوع والاستسلام للتبعية والانسياق يا بتينا". لا، لم ولن أخضع وأستسلم للتبعية ما حييت. كنتُ أرغب في إنشاء قوالب وتدرجات ألوان خاصة بي وإضافة إيقاعي الخاص للصورة المرسومة. وكانت أيام الكرنفال في كولونيا لا تُنسى في هذه الفترة. حيث شاركت في احتفالاتها طوال الليل.
سنوات الدراسة في أكاديمية الفنون مع بروفيسور هيرمان كاسبر في ميونيخ
ذهبتُ إلى هيرمان كاسبر في أكاديمية الفنون في ميونيخ مجددًا، بعد قضاء أربع سنوات مع أوتو جيرستر، في الصف الخاص بالرسم الجداري الضخم، حيثُ أبدعتُ بعض الجداريات. ويؤسفني أنني لم أتمكن من عمل الرسومات الجدارية في وقتٍ لاحق من حياتي مطلقًا. وإلى جانب الرسومات الجدارية كنا نرسم البورتريه يوميًا في ميونيخ. ونظرًا لغياب الشخص المقرر رسمه في أغلب الأوقات كان الرسامون يجلسون أحدهم في مواجهة الآخر ويرسمون أنفسهم. وفي ميونيخ تعرفت على طلاب اسكندنافيين. جميعهم كانوا مولعين بالرقص. كنتُ أرقصُ معهم ومع زميلي في مهنة الرسم بيتر هالفار كل ليلة في مدينة شوابينج الرائعة. كان هذا الولع بالرقص كبيرًا لدرجة أن رجلاً كبيرًا في السن زارني ذات يوم وطلب مني ألا أحث "متدربيه" على الرقص كل أمسية وذلك لأنه يغلبهم النعاس في صفه أثناء إلقاء المحاضرات والدروس.
في الأكاديمية الملكية للفنون مع بروفيسور بول سورينسن في كوبنهاغن
من المؤكد أن معرفتي بهذه المجموعة من السويديين والفنلنديين هي التي ألهمتني للانتقال إلى أكاديمية الفنون الملكية في كوبنهاغن، حيثُ كنتُ أول امرأةٍ ألمانية تلتحقُ بالأكاديمية بعد الحرب. واستقبلني بروفيسور بول سورينسن في الأكاديمية وأدخلني إلى صف الرسم. وانصب تركيزُ السيد بول سورينسن على رسم اللوحات الزيتية بصفةٍ أساسية. فكان يولِّي اهتمامًا كبيرًا للرسومات الكبيرة النابضة عن نماذج حية. ولن أنسى أبدًا تعبيره لي بأن الرسام سيكون ماهرًا وجاهزًا إذا تمكَّن من رسم تلةٍ فارغةٍ تعلوها الغيوم. لم أفهم حقًا ما كان يقصده بهذا التعبير، إلا عندما ذهبتُ إلى الجزائر. إذا تمكَّن الرسامُ من تحقيق ذلك وكان بإمكانه تقديم هذا الشكل المثير للاهتمام حقًا، فهو رسامٌ حقيقي. مثَّل الشتاءُ الطويل، الذي كانت تُفتح فيه الصفوفُ حتى منتصف الليل، تجربةً رائعة. حتى أنني حضرتُ الذكرى الخمسمئة لأكاديمية الفنون الملكية، حيثُ رأيتُ ملك الدنمارك وعائلته. في ذلك الوقت كان فن الرسم الدنماركي أكثر هدوءًا بكثير من فن أوروبا الوسطى، وهذا ما أجبرني على أن أكون هادئةً للغاية وكان لذلك طيبُ الأثر على رسوماتي.
الطرق الخاصة

غمرتني السعادةُ، رغم ذلك، عندما غادرتُ مدارس الفنون وخطوتُ في طرقي الخاصة مرةً أخرى في الرسم مفعمةً بالحيوية ومتأثرةً بصورةٍ خفية بالسيد إرفين بوفين. كانت رسوماته نابضةً بالحياة وكان انعكاسُ الشعور والحس مهمًا جدًا بالنسبة له، مثلي تمامًا. كما أنه أبدع رسوماتٍ رائعة لمدن تعلَّمتُ منها كثيرًا. ولم يكن تصوير منظور المدينة وحده ما يمثل تحديًا بالغ الصعوبة، بل كذلك منظور رسم منظر طبيعي. كما أنني رأيتُ في الجزائر أن الرسامين الشباب يرسمون القليل من المناظر الطبيعية أو لا يرسمونها على الإطلاق، لأنهم لم يتعلموا أبدًا رؤية هذا المنظور فيها. فتعلُّم الرؤية هو أهمُ شيءٍ قبل التدريب. وعندما ذهب معي إرفين بوفين إلى باريس في عام 1960 ليريني المتاحف ولرسم باريس، قابلتُ حينها الجزائريّ عبد الحميد عياش، الذي أصبح زوجي لاحقًا.
حياتي في الجزائر

حينما ذهبتُ إلى الجزائر لم يكن لديّ أيُّ تصورٍ عنها وكنتٌ مفتونةً بعقليةٍ تختلفُ تمام الاختلاف عن نظيرتها الأوروبية. ولكن ما لفت انتباهي أنها مدينةٌ تضيء بالكرامة والجمال الممزوجين بالطيبة. وفي عام 1962 دعاني معهد جوته في القاهرة لأعرض أعمالي. وقد لقي المعرض استقبالاً حافلاً ودعتني وزارة الثقافة المصرية للإقامة في فيلا الفنانين في الأقصر للرسم، حيثُ تعرَّفتُ على العديد من الرسامين والنحاتين من القاهرة. ومن ثم كان تعرفُّي على عالمٍ آخر وخيالٍ آخر ودينٍ آخر الحافز الأكبر في حياتي. وحينما رجعت لم يكن لدي إلا رغبة التعرُّف على الجزائر - وطن حميد - عن كثب. وفي بداية فبراير 1963 كانت الجزائر قد استقلت عن القوة الاستعمارية الفرنسية القديمة منذ ما يقارب 6 أشهر، ومن ثم سافرنا بالسفينة من مرسيليا إلى عنابة في شرقيّ الجزائر. ولن أنسى مطلقًا الساحل الورديّ لشمال أفريقيا، الذي كنت أطلُ عليه من السفينة. وجعلني هذا المنظر أشعر وكأنني وصلتُ إلى أرضٍ سحرية. وفي أول أسبوع من وصولنا إلى قالمة - مسقط رأس حميد - بدأتُ الرسم مجددًا. كانت صور المناظر الطبيعية الجزائرية الأولى لي ما تزالُ متأثرةً بالانطباعات الاسكندنافية. نادرًا ما كان المحيطُ الجبليُّ لمدينة قالمة بأوديتها الخصبة يتخذُ طابعًا ودودًا، بل كان قويًا ومُعبِّرًا، تمامًا كما في النرويج. كما أنني حاولتُ التقاط اللون المُحدَّد الذي يأتي جزئيًا من الضوء المذهل لشمال أفريقيا، لكنه كان أيضًا أقوى في ذاته من أيّ لونٍ أوروبيّ. بالإضافة إلى أن تربة مدينة قالمة كانت غنية بالحديد وبالتالي كان يغلبُ عليها اللونُ الأحمر. حيثُ تنمو أشجارُ الزيتون على هذه التربة الحمراء، واعتمادًا على الرياح والطقس، يمكن أن يغلبَ عليها اللونُ الأزرق الفاتح أو الأخضر المتباين. وكان الجزائريون يعتقدون أنها تتجوَّل في المناظر الطبيعية. أما أنا فكنتُ أراها ماساتٍ تتهادى في الحقول.
حياةٌ مُحقَّقة

كان الناس لطفاء معي، وبعد سبعة معارض فردية، اثنان منها في المتحف الوطني في الجزائر العاصمة، تمكَّنتُ من صنع اسمٍ كبير وقاعدةٍ راسخةٍ لنفسي هناك. كما كنتُ أعرضُ أعمالي أحيانًا 3 أو 4 مرات في السنة في أوروبا وفي بلادٍ عربيةٍ أخرى. وبالطبع تعرَّفتُ على الفنانين الجزائريين وأصبحوا بمثابة عائلتي. لأنه في الفن يبحث جميعُ الفنانين على وجه الأرض عن الشيء نفسه، حتى وإن كان نهجنا مختلفًا. رافقني عبد الحميد عياش، الذي كنتُ أطلقُ عليه اسم حميد، في كل دروبي المهنية في الفن من بعيد ولكن بكل حب وعاطفة. ولم أكن أعلم مدى حبه وحمايته لي من كل ما هو غريب وكيف كان يمثل قطبًا هادئًا في حياتي إلا بعد وفاته. أفتقده كثيرًا. لم أقدِّم هنا سوى لمحةً عامة بسيطة عن حياتي. وكان رفيقي الفني الأكثر أهمية، ولا يزال إلى اليوم، إرفين بوفين. وكان محفزي العاطفي الأكبر هو زوجي عبد الحميد عياش.

Bettina Heinen-Ayech, Guelma, Juni 1995

في 7 يونيو 2020 تُوفيت الفنانة عن عمرٍ يناهزُ 82 عامًا أثناء إقامتها مع عائلتها في ميونيخ. وقبل وفاتها بفترةٍ قصيرة أكملت صورة زهور وأعربت عن رغبتها في العودة إلى الجزائر قريبًا. وهي الآن مدفونة في مقبرة فالدفريدهوف في ميونيخ.